لا يهتم كثير من السياسيين والحقوقيين العرب بالنظر في حقوق “مواطني دولة إسرائيل” في ظل عدم اعتراف الشعوب العربية بدولة الكيان الإسرائيلي من الأساس. لكن الواقع أننا إذا تغافلنا عن كونه كيانا محتلا، وتعاملناه معه -افتراضا لأغراض تحليلية- كدولة حقيقية لها شعب ومواطنين ورعايا، ونظرنا إليه بعين المعايير الإنسانية والحقوقية، فإننا سنجد أنفسنا أمام مملكة ظلامية من العصور الوسطى.
فإذا أطلقنا فرضا على مستوطني كيان الاحتلال لقب مواطنين، فإنهم يعيشون في ظل دولة ثيوقراطية دينية ظلامية نموذجية، كأقبح ما تكون الدولة الثيوقراطية في تعريفات كتب السياسة والتاريخ، حيث يمثل كتاب التوراة بتفسيرات المتطرفين الحريدم عصب قوانين الدولة ودستورها.
هذا التطرف الذي يسيطر على تلك الدولة المفترضة، نتج عنه في النهاية مجموعة من القوانين القمعية التي لن تجد لها مثيلا في أي بقعة أخرى حول العالم، والتي لن تجد كثير مطالبات حقوقية دولية بالتخلي عنها وتصحيح مسارها، ويتم السكوت عنها خدمة للاحتلال وسمعته الدولية.
ولعل في مقدمة تلك القوانين القمعية في دولة الاحتلال منع الزواج المدني تماما، حيث يرفض اليهود الحريدم المتطرفون السماح بتعديل القانون الإسرائيلي لإتاحة الحق للمواطنين باختيار شريكة حياتهم بحرية دون فرض قيود توراتية تجبر اليهودي على الزواج حصرا من بنات ديانته.
وفي الوقت الذي تملأ فيه الجمعيات الحقوقية الغربية الدنيا صخبا لدعم حقوق الشواذ واتهام أي دولة ترفضها بمحاربة الحب والتضييق عليه، يتم التغاضي طوعا أو كرها عن دعم حقوق المواطنين الإسرائيلين في اختيار شريك حياتهم، وكأن هدا ليس محاربة للحب ولا تضييقا عليه!
وهكذا في إسرائيل فقط، يضطر “الأحباء” من ديانتين مختلفتين للسفر إلى دول قريبة مثل قبرص لتسجيل عقد زواجهما، وعند العودة إلى إسرائيل يخوضان حربا طاحنة لتسجيل زواجهما في المحكمة بعد رفع دعوى قضائية تكون الدولة نفسها هي الخصم فيها، في محاولة للتحايل على وصاية الحريدم المتطرفين وسيطرتهم على البلاد.
لا تنتهى معاناة الأحباء في إسرائيل هنا، حيث إنه حتى وبعد نجاحهما في توثيق زواجهما لدى الدولة بحكم نافذ من المحكمة، يظل أمامهما معركة أخرى تستمر لعقود في صالات المحاكم لانتزاع حق أولادهما في التوريث وامتلاك مستحقات والديهم، حيث سرعان ما ترفع جمعيات اليهود الحريدم المتطرفون عشرات الدعاوي القضائية ضد الزوجين مدعين امتلاكهم الوصاية على أملاك الزوجين بعد وفاتهما حتى في حال إنجابهما لأولاد بالغين.
كما يمنع القانون الإسرائيلي تجنيس أطفال غير اليهوديات أو غير الحاملات للجنسية الإسرائيلية ابتداءً، ويضطر الزوجان لرفع سلسلة دعاوى قضائية أخرى لانتزاع حق تجنيس أطفالهم، وعادة ما يكون خصمهم في تلك الدعاوى القضائية هم يهود الحريدم أنفسهم والذين يشترطون لتجنيس الأطفال أن يتم تسجيلهم في أحد تلك الجمعيات والتي ستتولي بعد ذلك عملية تأهليهم وتعليمهم في المدارس الدينية حتى مرحلة البلوغ.
وفي إسرائيل فقط أيضا، لا تمنح الجنسية إلا لليهود، حيث يشترط الدستور الإسرائيلي -وهو الوحيد في العالم في ذلك- على المتقدمين لنيل الجنسية الإسرائيلية تقديم ما يفيد اعتناقهم الديانة اليهودية، بل ويبسط اليهود الحريدم المتطرفون سيطرتهم أكثر، فيشترطون أن تكون أم المتقدم للتجنس هي الأخرى يهودية أبا عن جد.
ورغم ادعاءات الاحتلال بالتنوع العرقي للمواطنين، فإن واقع قوانين التجنيس هناك ينفي تماما هذا الادعاء، حيث وبالنظر إلى الإحصاءات الحكومية حول عمليات التجنيس في البلاد منذ العام 1948، وهو تاريخ إعلان دولة الكيان، لم تمنح جنسية البلاد نهائيا إلا لمن يقدم شهادة رسمية تفيد بكونه يهوديا أبا عن جد.
وهكذا إذا استطعت بطريقة ما أن تستخرج شهادة بكونك يهودي الديانة من أي دولة في العالم، يمكنك التوجه فورا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، والحصول على الجنسية الإسرائيلية في غضون أسابيع دون أي شروط أو قيود إقامة أخرى، وهذا القانون العنصري لن تجد له مثيلا في العالم كله إلا في إسرائيل، لكن العجيب هو أنك لن تجد أي احتجاج حقوقي يذكر على هذا القانون لدى بيانات المنظمات الحقوقية التي تنتفض في مناطق أخرى من العالم دفاعا عن قضايا البدون، وهي قضية عادلة بلا شك، لكن الصمت عن قوانين الاحتلال الاستثنائية التمييزية أيضا قضية عادلة بامتياز، فما سر هذا الصمت الحقوقي الدولي المريب!؟
لا تتوقف الاستثناءات العنصرية التمييزية في إسرائيل عند هذا الحد، بل تستمر لتضع اسم دولة إسرائيل منفردة في العالم كله كالدولة الوحيدة التي لا تمتلك حدودا رسمية معلنة، حيث يرفض يهود الحريدم المتطرفون الاعتراف بأي حدود لدولتهم سوى بالخريطة الكبرى من النيل إلى الفرات، ولا يعترفون بأي خرائط دولية تنزع عن تلك المناطق اسم إسرائيل وسيطرتها، ويعتبرون كل ما يؤمنون بسلطان دولتهم عليه أرضا محتلة تنتظر التحرير!
هذا التغاضى الإسرائيلي عن تمييز حدود بلادهم يقابله تغاضي آخر من المجتمع الدولي الذي يتذرع بكون القضية الفلسطينية لا تزال محل نزاع حتى اليوم وبالتالي لا داع لمطالبة دولة إسرائيل بتمييز حدودها! لتصبح بذلك حالة استثنائية فريدة في العالم كله، ولا يشبهها في ذلك أي بقعة أخرى حول العالم.
وهكذا نجد أن كيان الاحتلال -الذي تغاضينا واعتبرناه دولة افتراضية في هذا العرض- ليست سوى مملكة ظلامية من العصور الوسطى، غارقة تماما في سيطرة اليهود الحريدم المتطرفون، ويعيش مواطنوها تحت حكم ثيوقراطي عنصري تمييزي استثنائي، ولكنه لا يجد أي صدى غاضبا لدى المجتمع الدولي الذي يحابي إسرائيل ويرفض الحديث عن تلك المخازي في العرف الدولي خدمة لسمعة دولة الاحتلال.


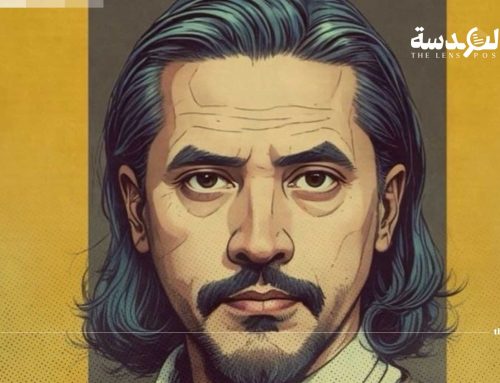




اضف تعليقا